-
×
 المفاتيح القرآنية لكتاب التراجم ولكتاب الشاهد لابن عربي | عبد الباقي مفتاح
£13.60
المفاتيح القرآنية لكتاب التراجم ولكتاب الشاهد لابن عربي | عبد الباقي مفتاح
£13.60 -
×
 فتاوى ابن عبد العال : العقد النفيس لما يحتاج اليه للفتوى والتدريس | مين الدين ابن عبد العال الحنفي
£10.20
فتاوى ابن عبد العال : العقد النفيس لما يحتاج اليه للفتوى والتدريس | مين الدين ابن عبد العال الحنفي
£10.20 -
×
 القواعد المشتركة بين اصول الفقه والقواعد الفقهية | سليمان بن سليم الرحيلي
£20.40
القواعد المشتركة بين اصول الفقه والقواعد الفقهية | سليمان بن سليم الرحيلي
£20.40
You may be interested in…




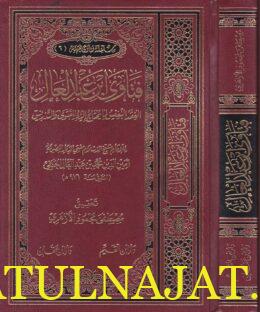 فتاوى ابن عبد العال : العقد النفيس لما يحتاج اليه للفتوى والتدريس | مين الدين ابن عبد العال الحنفي
فتاوى ابن عبد العال : العقد النفيس لما يحتاج اليه للفتوى والتدريس | مين الدين ابن عبد العال الحنفي  القواعد المشتركة بين اصول الفقه والقواعد الفقهية | سليمان بن سليم الرحيلي
القواعد المشتركة بين اصول الفقه والقواعد الفقهية | سليمان بن سليم الرحيلي 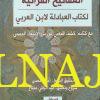






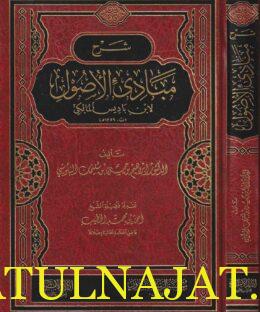




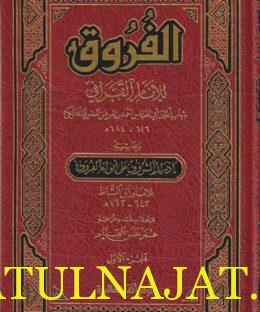
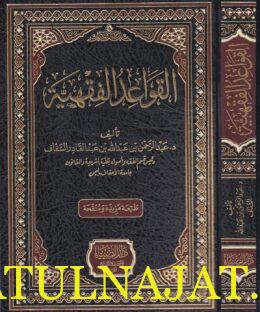

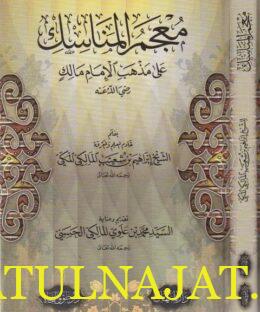
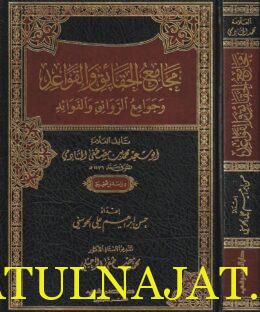
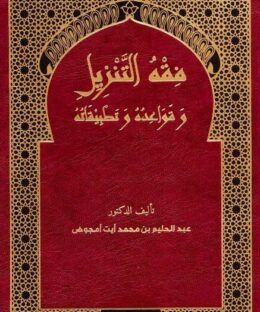
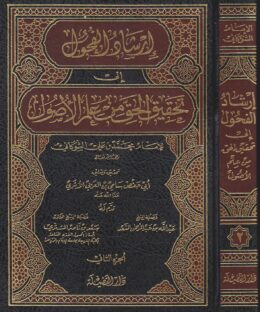

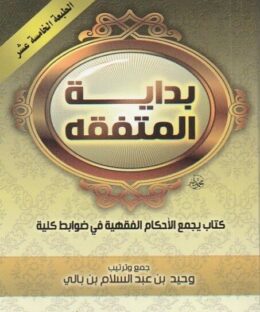

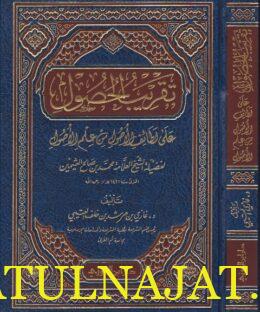

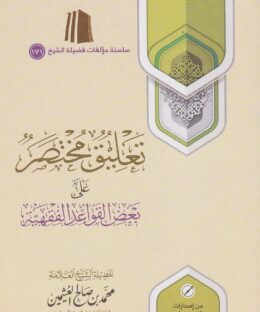
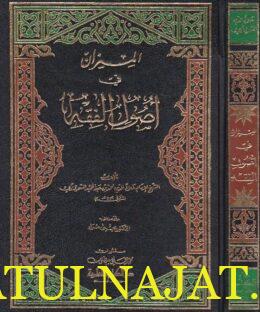


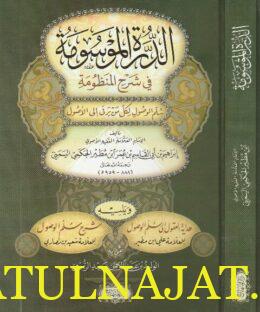
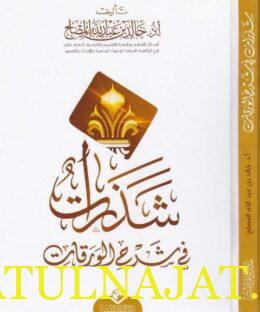


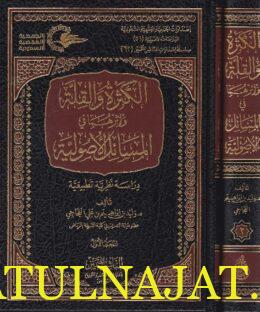
Reviews
There are no reviews yet.